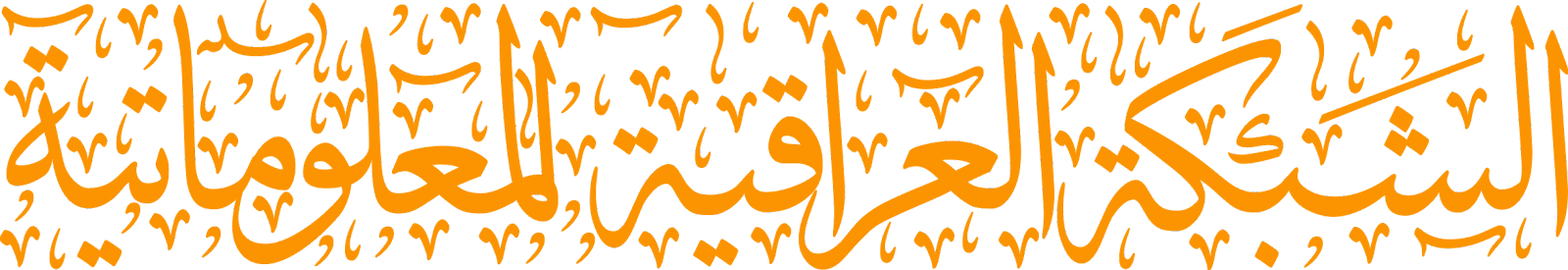أفق: أوطان لم نعد نعرفها ولا تعرفنا
د. شيرين أبو النجا , ناقدة وأكاديمية من مصر
بعد هجرات الفلسطينيين واللبنانيّين والعراقيين، ويليهم السوريون، بداعي الاحتلالات والحروب المفتوحة على المجهول..تساوى عرب الهجرة في مأساة ترك الأوطان والتيه خبط عشواء في منافي الأرض..
اختارت الدكتورة شيرين أبو النجا قراءة رواية الكاتبة العراقية المهاجرة إنعام كجّه جي، الصادرة حديثاً عن دار الجديد في بيروت بعنوان: “طشّاري”، أنموذجاً عن خارطة التمزق الفردي والجماعي بتضاريسها وأبعادها كافة.
كنا نعتقد في أوقات سابقة- بعيدة للغاية- أن الفلسطيني هو الذي اضطر لمغادرة وطنه، نفياً، أو طرداً من عدو محتلّ، أو هجرة بحثاً عن حياة آدمية، أو لجوءاً هرباً من الرصاص، ثم التحق به اللبناني بسبب حرب أهلية، في منتهى القسوة، ومن ثم انضمّ العراقي إلى الصورة، هرباً من معتقلات تعذيب، ومن كرمٍ فائض في التصفيات الجسدية. ولم يلبث السوداني أن سارع في اللجوء والهرب من معتقلات “الأشباح”، ومؤخراً كان الخروج من نصيب السوري، الذي يتقلّب في أتونه الناري، وهناك بعض من الجزائر ومصر الذين يكملون حلقة سفر الخروج المأسوي.
هجرة كانت أم نفياً أم لجوءاً، الكل يتساوى في مأساة مغادرة الوطن: البيت والأهل والأحباب، الروائح والطعام والموسيقى، اللغة والمسجد والكنيسة، ولكن ما باليد حيلة كما يقال، ما من حلّ آخر لمواجهة أوطان لم نعد نعرفها ولا تعرفنا. أقول ذلك على الرغم من أن المصري يعتبر انتقاله من مدينة إلى أخرى داخل البلد نفسه، بمثابة التجسيد الحقيقي لمعنى “الغربة”! إلا أن أسطورة “تقديس” الأوطان تتهاوى عندما يكون المكوث في الوطن بمثابة الغربة الحقّة، بل ربما يكون هذا أشد إيلاماً ووجعاً.
المواجهة مع الذات
تفعل الهجرة فعلها المباشر فتضع المهاجر والمنفي في مواجهة قاسية مع ذاته، وهي المواجهة التي تفسح مكاناً لذاكرة ثرية، ممزوجة بتساؤلات قاسية، لا تخلو أحياناً من رثاء الذات والوطن المبطن. إنه الفقد بكلّ ما تحمله الكلمة من معانٍ، فقد الوطن الذي لا يمكن استرجاعه، أو على الأقل استرجاع جزء منه، إلا بالحكي وبكتابة سيرته. من هنا أصبح لدى المكتبة العربية رصيداً جيداً من أدب المنفى، ذاك الأدب الذي يحكي، وبأشكال عدّة، سيرة وطن.
ثمة الكاتب الذي يرصد التحولات السياسية الكبرى، وثمة من يسلّط الضوء على تجربة بعينها، كتجربة المعتقل على سبيل المثال. وهناك من يمزج بين الاثنين. وهناك من يحكي صيرورة حياة الفرد، محوّلاً إياها إلى سيرة وطن، وهو ما تفعله العراقية إنعام كجّه جي في روايتها التي صدرت حديثاً عن دار الجديد بعنوان: “طشاري”، والكلمة تعني الرصاصة التي تخرج وتتشظّى في الاتجاهات كافة، كحال المهاجر العربي، وحال الأسرة، التي تنتمي إليها بطلة الرواية.
موجعة هي رواية “طشّاري” لأنها تستعيد مجد وازدهار وطن انقلب على أبنائه، فمسيرة الدكتورة “وردية”- طبيبة أمراض النساء منذ الخمسينيات- تؤكد أنه كان هناك وطن اسمه العراق، لا يعرف شعبه الفرقة ولا الطائفية. وفي رحلة كتابة عكسية تستعيد “وردية” العراق كوطنٍ بعد وصولها إلى باريس كمهاجرة. تبدو براعة الكاتبة في أنها استعادت لنا جزءاً من السيرة لا نعرفه كثيراً، ولم تركّز على التحولات السياسية، بل تركت القارئ يقوم بدوره في فهم الحدث، عبر إشارات “وردية”، التي لم تكن مهتمة كثيراً بالسياسة.
لقد أضفى ذلك، بالتحديد، على الرواية ملمحاً متميّزاً عن بقية كتابات المنفى، فتقول مثلاً، إن الحدث تزامن مع “تهجير اليهود”، أو أن كلمة “عفلقي”، كانت تشير إلى فئة بعينها. فعدم اهتمام “وردية” بالسياسة لم يوفّر لها عدم التورط بالسياسة، بل نبعت معظم مشكلاتها من ذلك، ناهيك بكونها مسيحية كلدانية من الموصل، وهو ما تحول في لحظة بعينها إلى مكمن خطر. إلا أن ذلك كان طوق نجاة للكاتبة أيضاً، التي أفلتت من ضرورة إعلان مواقف أيديولوجية، فتركز جلّ همّها على الوطن الذي ينفلت كحبات الرمل.
لا تقع إنعام كجّه جي في الخطاب السائد حول اضطهاد المسيحيين، فهي تصوّر التعامل اليومي الصادق بين المسلمين (سنّة وشيعة) والمسيحيين واليهود (آنذاك)، من دون افتعال خطاب تعايشٍ منمّق، ما يدلّ على التعددية الثقافية التي كانت سائدة في العراق (كانت الأوطان المهجورة كلّها هكذا).
مقابل ذلك، تنجح إنعام كجّه جي في رسم الوطن بأكمله وقد أصبح “مضطهداً”، واقعاً بكلّ طوائفه في براثن سلطة غاشمة. وفي استعادة “وردية” لأصوات مطربيها المفضلين، وحكيها عن اختلاف اللهجات، ما يؤكد ذاك التآلف والتسامح المجتمعي، حيث لم يشكل تجنّب ارتداء العباءة في بلدة الديوانية أمراً يثير حفيظة أهل المكان.
هجرة مختلفة عن سابقاتها
تبدو موجة الهجرة التي يُعاني منها العربي حديثاً، مختلفة عن هجرة القرن المنصرم، اختلافاً جذرياً. كان العربي في ذاك الوقت يزفر زفرته الأخيرة، ويغادر بحثاً عن الأمان، وهرباً من بعض السلطات القمعية التي لا تتعرف إلا على صوتها فقط. لكن القرن الحالي يشهد هجرة العربي الذي لم يعد يتعرّف إلى وطنه، ولم يعد وطنه يحنو عليه، الوطن أجمع، وليس السلطة فقط. هي قمة القسوة ألا يعود بإمكانك أن تتعرّف إلى ناسك ومكانك. وعلى الرغم من الحنين الذي يعتمل في صدور شخصيات الرواية (وفي صدور المهاجرين كلّهم)، إلا أنه يبدو حنيناً إلى ماضٍ ذهبي ولّى ولن يعود، ماضي الخمسينيات وما بعدها بعقد. ربما يكون الوجع في مسألة التشظّي، فأبناء الدكتورة “وردية” مبعثرون ما بين دبي وكندا وأميركا، ويتحول حفظها للمواقيت، المواقيت المختلفة لهذه البلدان، إلى أكبر علامة ألم لا يزول.
يجول العربي في أنحاء العالم ويحقّق ذاته في بلاد لا يتكلم لغتها، ولا يؤمن بدينها، ولا يتقبل طعامها، لكنه يشعر بآدميته. يحتم علينا هذا الأمر إعادة النظر في مسألة الهجرة، فقد أصبحت مؤخراً ضرورة للحفاظ على إنسانية معرضة للهدر.
إلا أننا نحن العرب، ومهما انفتحت لنا أبواب مغلقة، لا نتخلّى عن الحقيقة الأزلية في حياتنا: الموت. الكلّ يرغب في المغادرة، والكلّ يرغب أن يعود ليدفن في بلده، “بلد فذ ضربته لعنة الفرقة فمسخته وحشاً”. وكأن التشظي (الطشّاري)، الذي تفرضه علينا الغربة، يمكن تعويضه بالدفن في المكان نفسه. الموت…الموت… هو الحدث الذي تنتظره شخوص “طشّاري” ليلتئم الشمل، ومن هنا يعيد “إسكندر“- حفيد “وردية” – صوغ الهجرة والموت، طبقاً لمعطيات الحداثة. يتعرف إسكندر إلى ثقافة موطن والديه، عبر أحاديث لا نهائية عن الفقد والموت، ما يجعله يعمل على إنشاء مقبرة افتراضية على الإنترنت! فكرة مجنونة، وليست مستبعدة إطلاقاً، ولم لا، إذا كان جميع المهاجرين يتحولون إلى جيش هائل من النشطاء الإلكترونيّين؟! لماذا لا تتحول المقابر إلى فكرة افتراضية أيضاً؟. إنه المأزق النفسي الذي يجد فيه المهاجر نفسه، فمن ناحية توفّر له تلك المقبرة حلماً وهمياً بالأمان، ومن ناحية أخرى تشي هذه المقبرة الافتراضية بالوهم، الذي يُغذي النفس المتشظية، وهو الوهم الذي تسعى الكاتبة لهدمه، ولا تبقي له أثراً، فالكل يتراجع عن هذه الفكرة، ليسائل اسكندر عن سبب “الخيانة”. وكأن إنعام كجّه جي و”وردية” تقاومان معاً حالة الطشّاري.
المدهش في رواية “طشّاري” هو أنها لا تقصر الإحساس بالغربة والاغتراب على أهل العراق المهاجرين. وهذا ما يجعلها رواية ملتحمة بكتلٍ إنسانية متفرقة لا نعلم عنها شيئاً. فالمقارنة الضمنية بالسكان الأصليين لكندا عبر “ياسمين”، التي تعمل طبيبة هناك، يؤكد على جوهر القمع والتجاهل والشعور بالاغتراب. هكذا تنجح وردية والكاتبة في تغيير مفهوم الهوية، التي كانت في ما مضى تقتصر على البلد واللغة والدين والثقافة نفسها. بالتالي يتحول مفهوم الهجرة، وبدلاً من الانغلاق على مشكلة ذات خصوصية، ينفتح الأمر على مجال واسع من الغربة وهجر الوطن، ليصبح السؤال ملحّاً حقاً: ما هو الوطن؟ ولكن “يا لهذه الذاكرة التي تعاند، وتحتفظ بكلّ شيء، وترفض أن تتنازل عن التفاصيل”؛ بالطبع، وماذا نفعل في الذاكرة، تلك الذاكرة التي ترفض ترك مكانها للحاضر؟ إنها محاولة الطشّاري الممزق بين أجزاء عدّة وأمكنة مختلفة؛ هي محاولة يلتئم جرحها بالكتابة، كتابة سيرة الوطن.
د. شيرين أبو النجا , ناقدة وأكاديمية من مصر
بعد هجرات الفلسطينيين واللبنانيّين والعراقيين، ويليهم السوريون، بداعي الاحتلالات والحروب المفتوحة على المجهول..تساوى عرب الهجرة في مأساة ترك الأوطان والتيه خبط عشواء في منافي الأرض..
اختارت الدكتورة شيرين أبو النجا قراءة رواية الكاتبة العراقية المهاجرة إنعام كجّه جي، الصادرة حديثاً عن دار الجديد في بيروت بعنوان: “طشّاري”، أنموذجاً عن خارطة التمزق الفردي والجماعي بتضاريسها وأبعادها كافة.
كنا نعتقد في أوقات سابقة- بعيدة للغاية- أن الفلسطيني هو الذي اضطر لمغادرة وطنه، نفياً، أو طرداً من عدو محتلّ، أو هجرة بحثاً عن حياة آدمية، أو لجوءاً هرباً من الرصاص، ثم التحق به اللبناني بسبب حرب أهلية، في منتهى القسوة، ومن ثم انضمّ العراقي إلى الصورة، هرباً من معتقلات تعذيب، ومن كرمٍ فائض في التصفيات الجسدية. ولم يلبث السوداني أن سارع في اللجوء والهرب من معتقلات “الأشباح”، ومؤخراً كان الخروج من نصيب السوري، الذي يتقلّب في أتونه الناري، وهناك بعض من الجزائر ومصر الذين يكملون حلقة سفر الخروج المأسوي.
هجرة كانت أم نفياً أم لجوءاً، الكل يتساوى في مأساة مغادرة الوطن: البيت والأهل والأحباب، الروائح والطعام والموسيقى، اللغة والمسجد والكنيسة، ولكن ما باليد حيلة كما يقال، ما من حلّ آخر لمواجهة أوطان لم نعد نعرفها ولا تعرفنا. أقول ذلك على الرغم من أن المصري يعتبر انتقاله من مدينة إلى أخرى داخل البلد نفسه، بمثابة التجسيد الحقيقي لمعنى “الغربة”! إلا أن أسطورة “تقديس” الأوطان تتهاوى عندما يكون المكوث في الوطن بمثابة الغربة الحقّة، بل ربما يكون هذا أشد إيلاماً ووجعاً.
المواجهة مع الذات
تفعل الهجرة فعلها المباشر فتضع المهاجر والمنفي في مواجهة قاسية مع ذاته، وهي المواجهة التي تفسح مكاناً لذاكرة ثرية، ممزوجة بتساؤلات قاسية، لا تخلو أحياناً من رثاء الذات والوطن المبطن. إنه الفقد بكلّ ما تحمله الكلمة من معانٍ، فقد الوطن الذي لا يمكن استرجاعه، أو على الأقل استرجاع جزء منه، إلا بالحكي وبكتابة سيرته. من هنا أصبح لدى المكتبة العربية رصيداً جيداً من أدب المنفى، ذاك الأدب الذي يحكي، وبأشكال عدّة، سيرة وطن.
ثمة الكاتب الذي يرصد التحولات السياسية الكبرى، وثمة من يسلّط الضوء على تجربة بعينها، كتجربة المعتقل على سبيل المثال. وهناك من يمزج بين الاثنين. وهناك من يحكي صيرورة حياة الفرد، محوّلاً إياها إلى سيرة وطن، وهو ما تفعله العراقية إنعام كجّه جي في روايتها التي صدرت حديثاً عن دار الجديد بعنوان: “طشاري”، والكلمة تعني الرصاصة التي تخرج وتتشظّى في الاتجاهات كافة، كحال المهاجر العربي، وحال الأسرة، التي تنتمي إليها بطلة الرواية.
موجعة هي رواية “طشّاري” لأنها تستعيد مجد وازدهار وطن انقلب على أبنائه، فمسيرة الدكتورة “وردية”- طبيبة أمراض النساء منذ الخمسينيات- تؤكد أنه كان هناك وطن اسمه العراق، لا يعرف شعبه الفرقة ولا الطائفية. وفي رحلة كتابة عكسية تستعيد “وردية” العراق كوطنٍ بعد وصولها إلى باريس كمهاجرة. تبدو براعة الكاتبة في أنها استعادت لنا جزءاً من السيرة لا نعرفه كثيراً، ولم تركّز على التحولات السياسية، بل تركت القارئ يقوم بدوره في فهم الحدث، عبر إشارات “وردية”، التي لم تكن مهتمة كثيراً بالسياسة.
لقد أضفى ذلك، بالتحديد، على الرواية ملمحاً متميّزاً عن بقية كتابات المنفى، فتقول مثلاً، إن الحدث تزامن مع “تهجير اليهود”، أو أن كلمة “عفلقي”، كانت تشير إلى فئة بعينها. فعدم اهتمام “وردية” بالسياسة لم يوفّر لها عدم التورط بالسياسة، بل نبعت معظم مشكلاتها من ذلك، ناهيك بكونها مسيحية كلدانية من الموصل، وهو ما تحول في لحظة بعينها إلى مكمن خطر. إلا أن ذلك كان طوق نجاة للكاتبة أيضاً، التي أفلتت من ضرورة إعلان مواقف أيديولوجية، فتركز جلّ همّها على الوطن الذي ينفلت كحبات الرمل.
لا تقع إنعام كجّه جي في الخطاب السائد حول اضطهاد المسيحيين، فهي تصوّر التعامل اليومي الصادق بين المسلمين (سنّة وشيعة) والمسيحيين واليهود (آنذاك)، من دون افتعال خطاب تعايشٍ منمّق، ما يدلّ على التعددية الثقافية التي كانت سائدة في العراق (كانت الأوطان المهجورة كلّها هكذا).
مقابل ذلك، تنجح إنعام كجّه جي في رسم الوطن بأكمله وقد أصبح “مضطهداً”، واقعاً بكلّ طوائفه في براثن سلطة غاشمة. وفي استعادة “وردية” لأصوات مطربيها المفضلين، وحكيها عن اختلاف اللهجات، ما يؤكد ذاك التآلف والتسامح المجتمعي، حيث لم يشكل تجنّب ارتداء العباءة في بلدة الديوانية أمراً يثير حفيظة أهل المكان.
هجرة مختلفة عن سابقاتها
تبدو موجة الهجرة التي يُعاني منها العربي حديثاً، مختلفة عن هجرة القرن المنصرم، اختلافاً جذرياً. كان العربي في ذاك الوقت يزفر زفرته الأخيرة، ويغادر بحثاً عن الأمان، وهرباً من بعض السلطات القمعية التي لا تتعرف إلا على صوتها فقط. لكن القرن الحالي يشهد هجرة العربي الذي لم يعد يتعرّف إلى وطنه، ولم يعد وطنه يحنو عليه، الوطن أجمع، وليس السلطة فقط. هي قمة القسوة ألا يعود بإمكانك أن تتعرّف إلى ناسك ومكانك. وعلى الرغم من الحنين الذي يعتمل في صدور شخصيات الرواية (وفي صدور المهاجرين كلّهم)، إلا أنه يبدو حنيناً إلى ماضٍ ذهبي ولّى ولن يعود، ماضي الخمسينيات وما بعدها بعقد. ربما يكون الوجع في مسألة التشظّي، فأبناء الدكتورة “وردية” مبعثرون ما بين دبي وكندا وأميركا، ويتحول حفظها للمواقيت، المواقيت المختلفة لهذه البلدان، إلى أكبر علامة ألم لا يزول.
يجول العربي في أنحاء العالم ويحقّق ذاته في بلاد لا يتكلم لغتها، ولا يؤمن بدينها، ولا يتقبل طعامها، لكنه يشعر بآدميته. يحتم علينا هذا الأمر إعادة النظر في مسألة الهجرة، فقد أصبحت مؤخراً ضرورة للحفاظ على إنسانية معرضة للهدر.
إلا أننا نحن العرب، ومهما انفتحت لنا أبواب مغلقة، لا نتخلّى عن الحقيقة الأزلية في حياتنا: الموت. الكلّ يرغب في المغادرة، والكلّ يرغب أن يعود ليدفن في بلده، “بلد فذ ضربته لعنة الفرقة فمسخته وحشاً”. وكأن التشظي (الطشّاري)، الذي تفرضه علينا الغربة، يمكن تعويضه بالدفن في المكان نفسه. الموت…الموت… هو الحدث الذي تنتظره شخوص “طشّاري” ليلتئم الشمل، ومن هنا يعيد “إسكندر“- حفيد “وردية” – صوغ الهجرة والموت، طبقاً لمعطيات الحداثة. يتعرف إسكندر إلى ثقافة موطن والديه، عبر أحاديث لا نهائية عن الفقد والموت، ما يجعله يعمل على إنشاء مقبرة افتراضية على الإنترنت! فكرة مجنونة، وليست مستبعدة إطلاقاً، ولم لا، إذا كان جميع المهاجرين يتحولون إلى جيش هائل من النشطاء الإلكترونيّين؟! لماذا لا تتحول المقابر إلى فكرة افتراضية أيضاً؟. إنه المأزق النفسي الذي يجد فيه المهاجر نفسه، فمن ناحية توفّر له تلك المقبرة حلماً وهمياً بالأمان، ومن ناحية أخرى تشي هذه المقبرة الافتراضية بالوهم، الذي يُغذي النفس المتشظية، وهو الوهم الذي تسعى الكاتبة لهدمه، ولا تبقي له أثراً، فالكل يتراجع عن هذه الفكرة، ليسائل اسكندر عن سبب “الخيانة”. وكأن إنعام كجّه جي و”وردية” تقاومان معاً حالة الطشّاري.
المدهش في رواية “طشّاري” هو أنها لا تقصر الإحساس بالغربة والاغتراب على أهل العراق المهاجرين. وهذا ما يجعلها رواية ملتحمة بكتلٍ إنسانية متفرقة لا نعلم عنها شيئاً. فالمقارنة الضمنية بالسكان الأصليين لكندا عبر “ياسمين”، التي تعمل طبيبة هناك، يؤكد على جوهر القمع والتجاهل والشعور بالاغتراب. هكذا تنجح وردية والكاتبة في تغيير مفهوم الهوية، التي كانت في ما مضى تقتصر على البلد واللغة والدين والثقافة نفسها. بالتالي يتحول مفهوم الهجرة، وبدلاً من الانغلاق على مشكلة ذات خصوصية، ينفتح الأمر على مجال واسع من الغربة وهجر الوطن، ليصبح السؤال ملحّاً حقاً: ما هو الوطن؟ ولكن “يا لهذه الذاكرة التي تعاند، وتحتفظ بكلّ شيء، وترفض أن تتنازل عن التفاصيل”؛ بالطبع، وماذا نفعل في الذاكرة، تلك الذاكرة التي ترفض ترك مكانها للحاضر؟ إنها محاولة الطشّاري الممزق بين أجزاء عدّة وأمكنة مختلفة؛ هي محاولة يلتئم جرحها بالكتابة، كتابة سيرة الوطن.